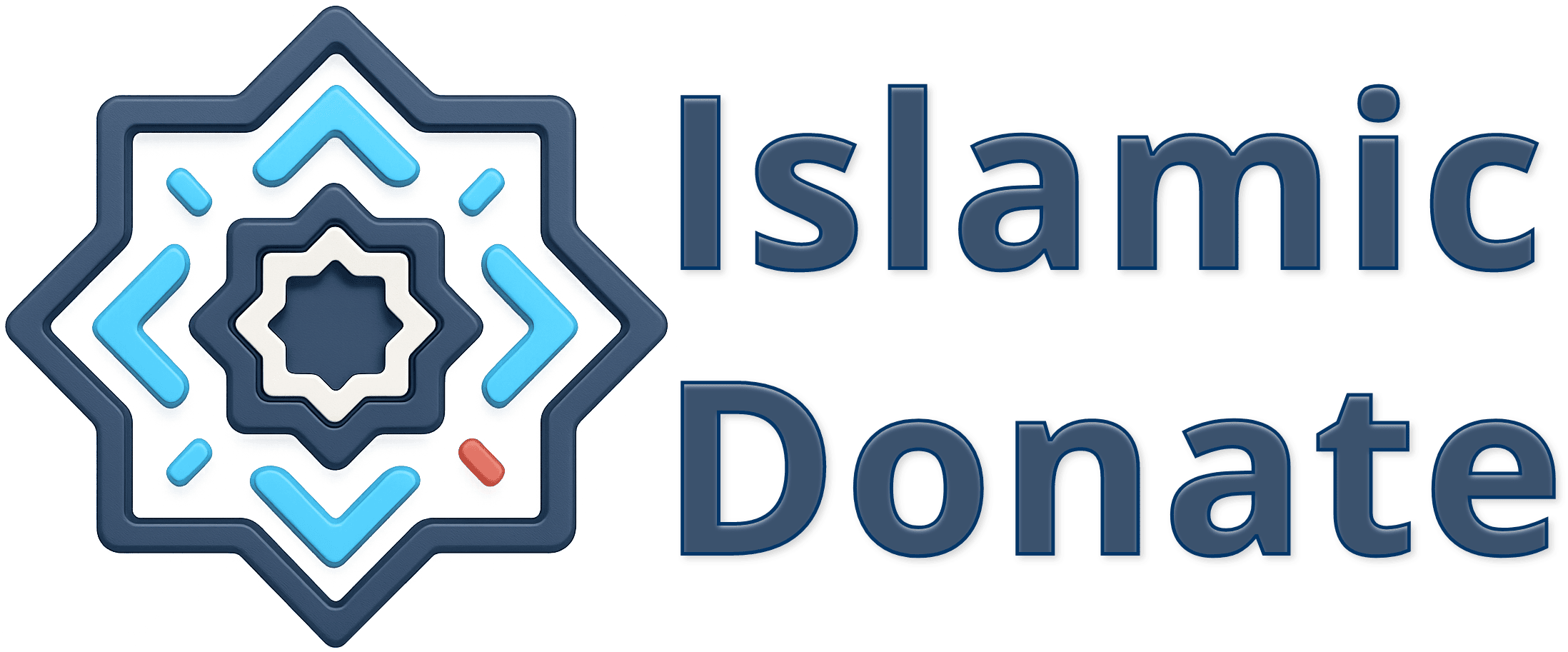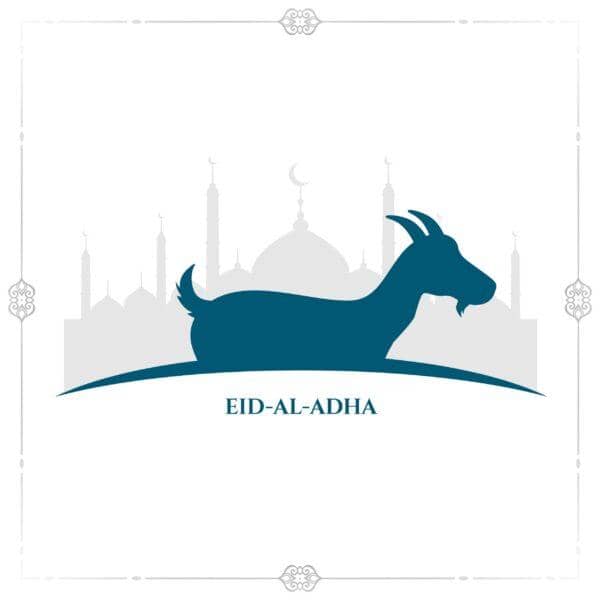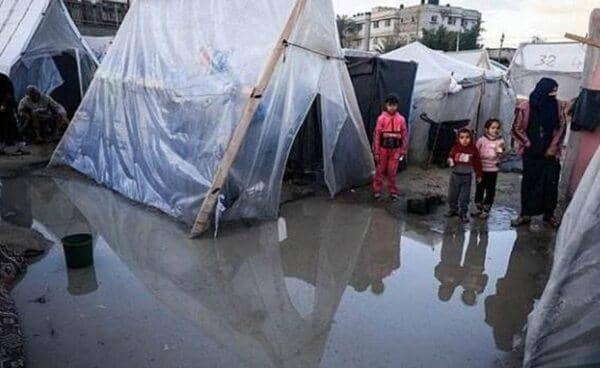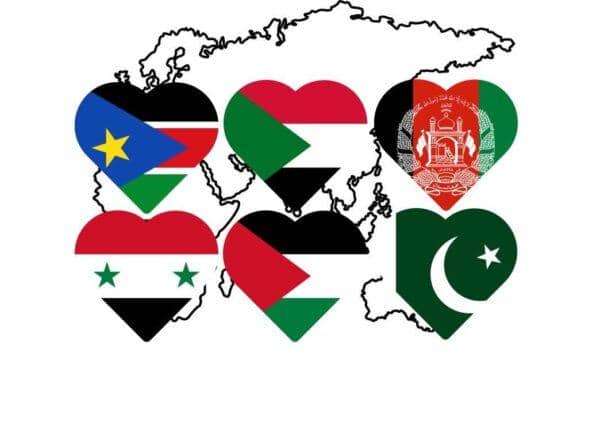آية الله العظمى سيد حسين بروجردي
اسم الأب: الحاج سيد علي
تاريخ الميلاد: التاريخ الإسلامي: صفر 1292 / الإنجليزية التاريخ: 23 مارس 1875
مكان الميلاد: بوروجرد ، إيران
أماكن التعليم: بروجر ، أصفهان ، النجف ، مشهد وقم.
مكان الدفن: ضريح حضرة معصومة (عليه السلام) في مدينة قم في 13 شوال 1380/31 آذار 1961 (88 سنة).
كان آية الله العظمى السيد حسين بروجردي (مارس 1875 – 30 مارس 1961) من المراجع الشيعية المسلم والمرجح الرائد في إيران منذ عام 1947 تقريبًا حتى وفاته في عام 1961. ولأكثر من 15 عامًا كان يُعرف بأعلى سلطة شيعية ، يتمتع آية الله العظمى بسلطة اتخاذ قرارات قانونية ضمن حدود الشريعة الإسلامية للأتباع ورجال الدين الأقل اعتمادًا. كان أيضًا رئيسًا لمؤسسة تعليمية (تسمى أحيانًا الإكليريكيين أو Howzat) في اللاهوت ، لإعداد الطلاب للرسامة كرجال دين.
بذل آية الله العظمى السيد حسين بروجردي جهودًا ملحوظة لتطوير الأماكن الدينية والثقافية وعلماء اللاهوت والمكتبات ونشر الكتب الدينية. على سبيل المثال ، تم بناء مسجد الأعظم في قم والمركز الإسلامي هامبورغ ومدرسة جهانجير خان الدينية ومدرسة كرمانشاه الدينية ومدرسة النجف أشرف بالإضافة إلى العديد من المكتبات في كرمانشاه والنجف خلال حياته.
في 12 فبراير 1960 ، أمر بتأسيس مكتبة عامة كبيرة في جامع الأعظم بقم. أقيم حفل الافتتاح رسميًا في 13 أبريل 1961 من قبل ابنه محمد حسين بروجردي ، آية الله يميل حقًا إلى الاستخدام العام للمكتبة. كان يرأس المكتبة آية الله دانيش أشتياني.
آية الله سيد جواد علوي بوروجردي (حفيده) ، مسؤول عن مسجد العزام الكبير والمكتبة والمراكز الأخرى ذات الصلة بأمره ، وتم تجديد مبنى المكتبة وإعادة افتتاحه في عام 2009 وتم النظر في قسم منفصل للنساء.
في عام 2002 ، تم اختيار مكتبة آية الله بوروجردي من قبل مؤسسة المكتبات العامة كأفضل مكتبة في محافظة قم ، وبعد ذلك في عام 2005 قامت دائرة الثقافة والإرشاد الإسلامي في إيران بترشيح هذه المكتبة وتقديرها لتقديمها خدمة فائقة
في عام 2011 ، تم تسمية مكتبة آية الله العظمى بوروجردي تقديراً وتقديراً للخدمات الرائعة للباحثين كمكتبة مختارة من قبل المجلس الأكاديمي لندوة الكتاب السنوية الثالثة عشر في Howzat.