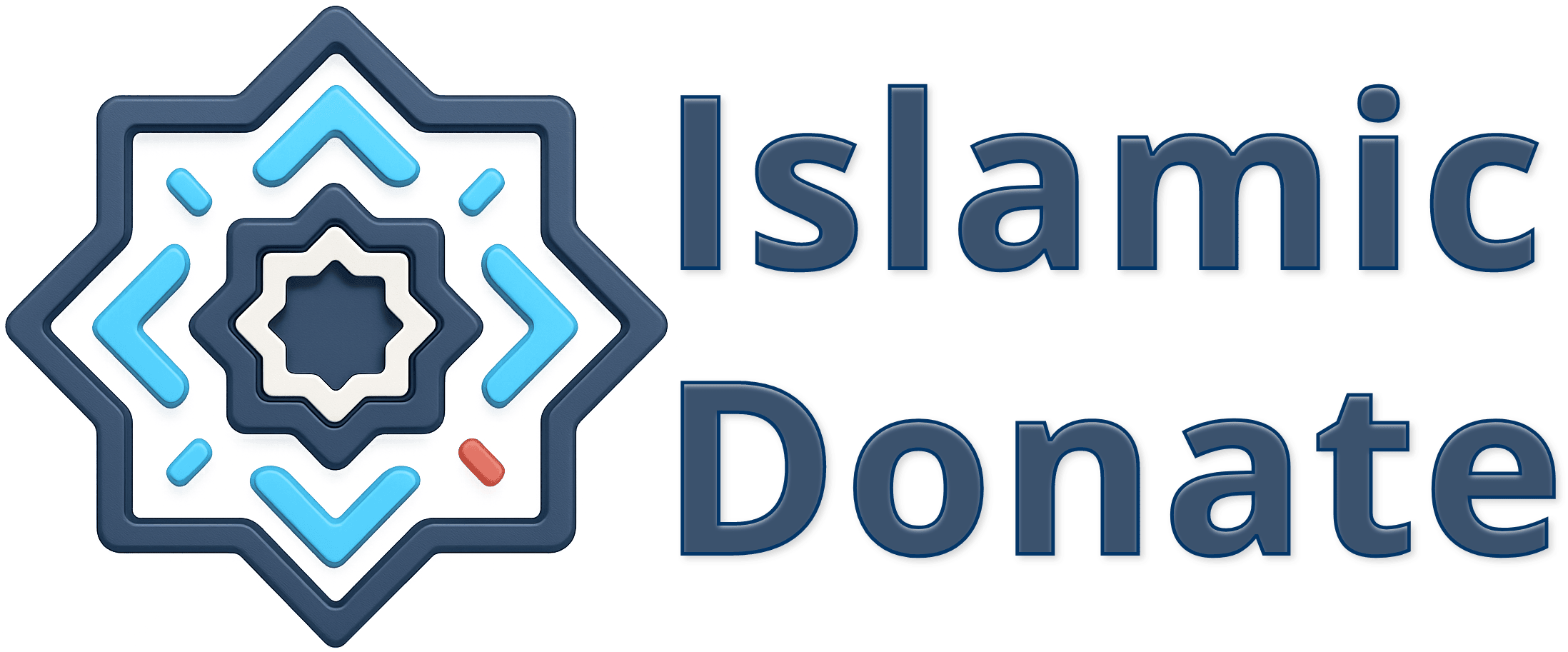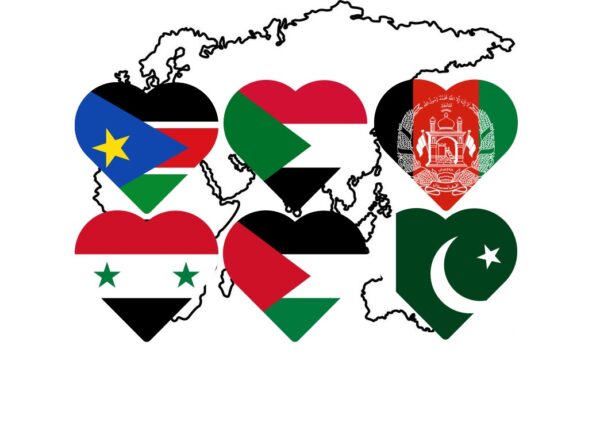الخمس (أيضًا تهجئة الخمس أو الخمس) هو مصطلح يستخدم في التقاليد الإسلامية للإشارة إلى ضريبة أو ضريبة معينة مطلوبة من بعض المسلمين. في المذهب الشيعي من الإسلام ، يعد الخمس أحد أركان الإسلام الخمسة ويعتبر واجبًا إلزاميًا على جميع المسلمين.
ورد مفهوم الخمس في عدة آيات من القرآن الكريم منها:
سورة الأنفال الآية 41: واعلم أنه من كل غنائم الحرب التي يجوز لك أن تأخذها خُمسُها لله ، وللرسول ، وللأقرباء ، وللأيتام. والمسكين وعابر السبيل “.
سورة آل عمران ، الآية 92: “لا يقتل المؤمن مؤمنًا أبدًا ، ولكن (إذا حصل) عن طريق الخطأ (التعويض): إذا قتل المرء مؤمنًا فيُحرر مؤمنًا. يؤمن بالعبد ، ويدفع التعويض لأهل المتوفى ، ما لم يحوِّلوه بحرية ، فإذا كان المتوفى لقوم يحاربك ، وكان مؤمناً ، يكفي تحرير العبد المؤمن. شعب تربطكم به معاهدة تحالف متبادل ، والتعويض (يجب أن يُدفع) لعائلته ، ويطلق سراح العبد المؤمن. بالنسبة لأولئك الذين يجدون هذا فوق إمكانياتهم ، (يشرع) صيام شهرين متتاليين. بالمناسبة من التوبة إلى الله: لأن الله عنده كل علم وكل حكمة.
توصف الخُمس في هذه الآيات بأنها ضريبة أو جباية مطلوبة من بعض المسلمين ، وتذهب عائداتها لدعم قضايا معينة ، مثل الفقراء والأيتام والأرامل. في التقليد الشيعي ، يُفهم الخُمس عادةً على أنه ضريبة على أنواع معينة من الدخل أو الثروة التي يجب دفعها مرة واحدة في السنة. يتم احتسابها عادة كنسبة مئوية من دخل الفرد أو ثروته وتستخدم لدعم احتياجات المجتمع ، بما في ذلك الفقراء والأيتام والأرامل وغيرهم من المحتاجين.
من المهم ملاحظة أن مفهوم الخمس خاص بالتقاليد الشيعية ولا يمارسه جميع المسلمين. في التقليد السني ، لا يعتبر الخُمس أحد أركان الإسلام الخمسة وليس واجبًا إلزاميًا.