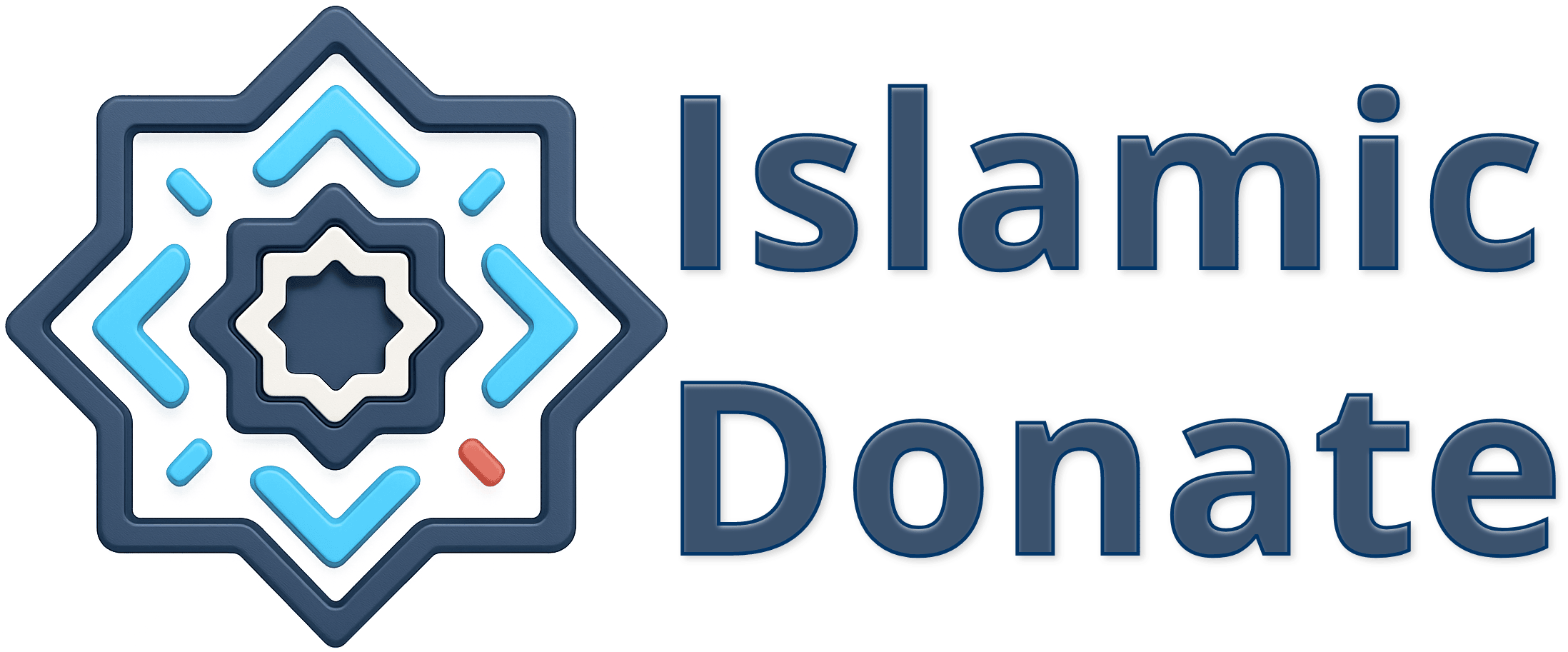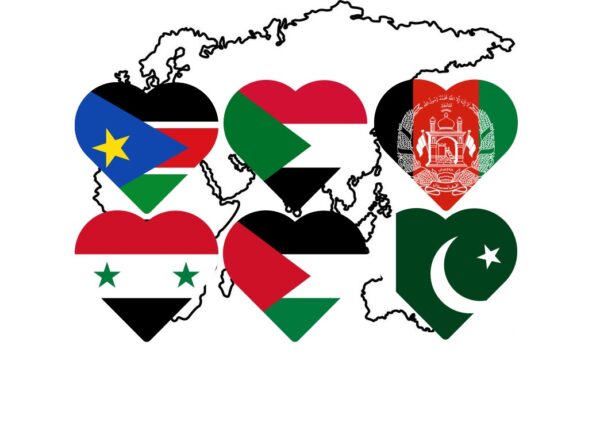عام الفيل، يشير إلي حادثة هجوم جيش حاكم اليمن أبرهة (أبرهة الأشرم) على الكعبة الشريفة من جانب مملكة أكسوم الحبشية؛ ليجبر أهل مكة وقريش على الذهاب إلى كنيسة القليس التي بناها، وزيّنها في اليمن، لكن أهل مكة لم يهتموا بها، بل وصل الأمر بأحدهم أن أهانها ودخلها ليلاً ليقضي حاجته فيها، مما أغضب أبرهة الحبشي، وعلى أشهر الأقوال أن النبي (ص) ولد في هذه السنة.
وجه التسمية وقضية أبرهة وعبد المطلب
خرج أبرهة بجيش عظيم ومعه فِيَلَة كبيرة تتقدم الجيش لتدمير الكعبة، وعندما اقترب من مكة المكرمة، وجد قطيعاً من النوق لعبد المطلب سيد قريش فأخذها غصباً. فخرج عبد المطلب، جدّ الرسول محمد ![]() طالباً منه أن يرد له نوقه ويترك الكعبة وشأنها، فردّ أبرهة نوق عبد المطلب، لكنه رفض الرجوع عن مكة. أما أهل مكة فخرجوا هاربين إلى الجبال المحيطة بالكعبة خوفاً من أبرهة وجنوده والفِيَلَة التي هجم بواستطها.
طالباً منه أن يرد له نوقه ويترك الكعبة وشأنها، فردّ أبرهة نوق عبد المطلب، لكنه رفض الرجوع عن مكة. أما أهل مكة فخرجوا هاربين إلى الجبال المحيطة بالكعبة خوفاً من أبرهة وجنوده والفِيَلَة التي هجم بواستطها.
عندما ذهب عبد المطلب ليسترد نوقه سأله أبرهة لماذا لا تدافع عن الكعبة فأجابه: “أما النوق فأنا ربها، وأما الكعبة فلها ربّ يحميها “. وعندما رفض أبرهة طلب عبد المطلب أبت الفيلة التقدم نحو مكة، وأرسل الله سبحانه وتعالى طيوراً أبابيل تحمل معها حجارة من سجيل، فقتلتهم وشتتت أشلائهم.
واشتهر أن في ذلك العام كان مولد رسول الله (ص) الذي يصادف عام 570 ميلادية، كما يعتقد البعض أن عام الفيل كان بين 568 و569 ميلادية. ووجه تسمية العام بعام الفيل كان لأجل الهجوم بواسطة الفيلة على الكعبة.
سورة الفيل
وقد ذكر الله تعالى هذه الحادثة في سورة من القرآن الكريم وهي سورة الفيل قال تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (1) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (2) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ (3) تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ (4) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ (5)﴾
أهمية عام الفيل
جعل العرب هذه الواقعة كمبدء لتاريخهم وسميهم بعام الفيل. ولم يكن النبي![]() انذاك مولودا وولد بعد شهرين وسبعة عشر يوماً، ولهذا السبب عدّوا السنة الأولى من حياته ضمن عام الفيل.
انذاك مولودا وولد بعد شهرين وسبعة عشر يوماً، ولهذا السبب عدّوا السنة الأولى من حياته ضمن عام الفيل.
سبب الغارة
نقل أن أبرهة بعد التسلط على اليمن بني كنيسة في منطقة صنعاء باسم قليس وكتب في رسالة إلى حاكم الحبشة: أنني بنيت كنيسة لم أرى قبل اليوم مثيلا لها. وسوف آتي بزوار الكعبة إليها بعد الإنهاء من عملها.
بعد نشر مضمون هذه الرسالة بين العرب قام رجل من بني فقيم بتلويث الكنيسة بالقذارات. جعل أبرهة هذا الأمر ذريعة لتخريب الكعبة ثم هيأ جيشا كبيرا مع 14 فيلا.
المقاومة ضد أبرهة
قاوم أبرهة شخصان من كبار اليمن باسم ذو نفر ونفيل بن حبيب خثعمي لكنهما انهزما وأسرهما الأبرهة.
رسالة لعبد المطلب
أرسل أبرهة رسالة إلى عبد المطلب رئيس قريش، قائلا فيها «جئت لهدم الكعبة فحسب وما أتيت حتّى أقتل شخصاً».
ثم ذهب عبدالمطلب لزيارة أبرهة وطلب منه أن يرجع 200 إبل. تعجب أبرهة من مقاله وقال له: «مع كل هذه العظمة التي كنا نعرف منك كيف طلبت منّي هذا الطلب البسيط؟ وقد رأيتني قاصدا هدم الكعبة التي تقدسها أنت وابائك!».
فأجابه عبدالمطلب: انا ربّ الابل وللبيت ربّ يمنعه. فقال أبرهة متبخترا: «ليس هناك أحد يمنعني عن الوصول إلى هدفي.» ثم أمر بإرجاع نياقه.
خروج قريش من مكة
حينما أخذ عبد المطلب الإبل رجع إلى قريش وأخبرهم بنية أبرهة، وأنه يُريد الهجوم على الكعبة، فأمرهم أن يخرجوا من مكة ويلجئوا إلى الجبل. فجمع عبد المطلب وُلده و من معه، ثمّ جاء إلى باب الكعبة، فتعلّق به وقال: ”يـا ربّ انّ العبد يمنع رحْلَهُ فامنع رحالك، لا يغلبـنَّ صليبهـم ومحالهم أبـدا محـالك“.
هجوم أبابيل على جيش أبرهة
إثر تحرك جيش الأبرهة باتجاه الكعبة، أرسل الله تعالى طيراً من السماء باسم أبابيل وهي تحمل حصاة من منقارها لتهلك أعداء البيت. وبعد «عام الفيل» حظيت قريش بمنزلة كريمة عند العرب. ذكر فخر الرازى عن عكرمة عن ابن عباس وسعيد بن جبير: «لما ارسل الله الحجارة على أصحاب الفيل لم يقع حجر على أحد منهم إلا نفط جلده وثار به الجدرى » هناك نقل اخر من ابن عباس حول ما وقع بعد إصابتهم بالحصاة… «فما بقى أحد منهم إلا أخذته الحكة، فكان لا يحك انسان منهم جلده إلا تساقط لحمه». فجعلت ترميهم بها حتى جدرت أجسادهم فقتلهم بها وما كان قبل ذلك رؤى شيىء من الجدرى، ولارؤا ذلك من الطير قبل ذلك اليوم ولا بعده.