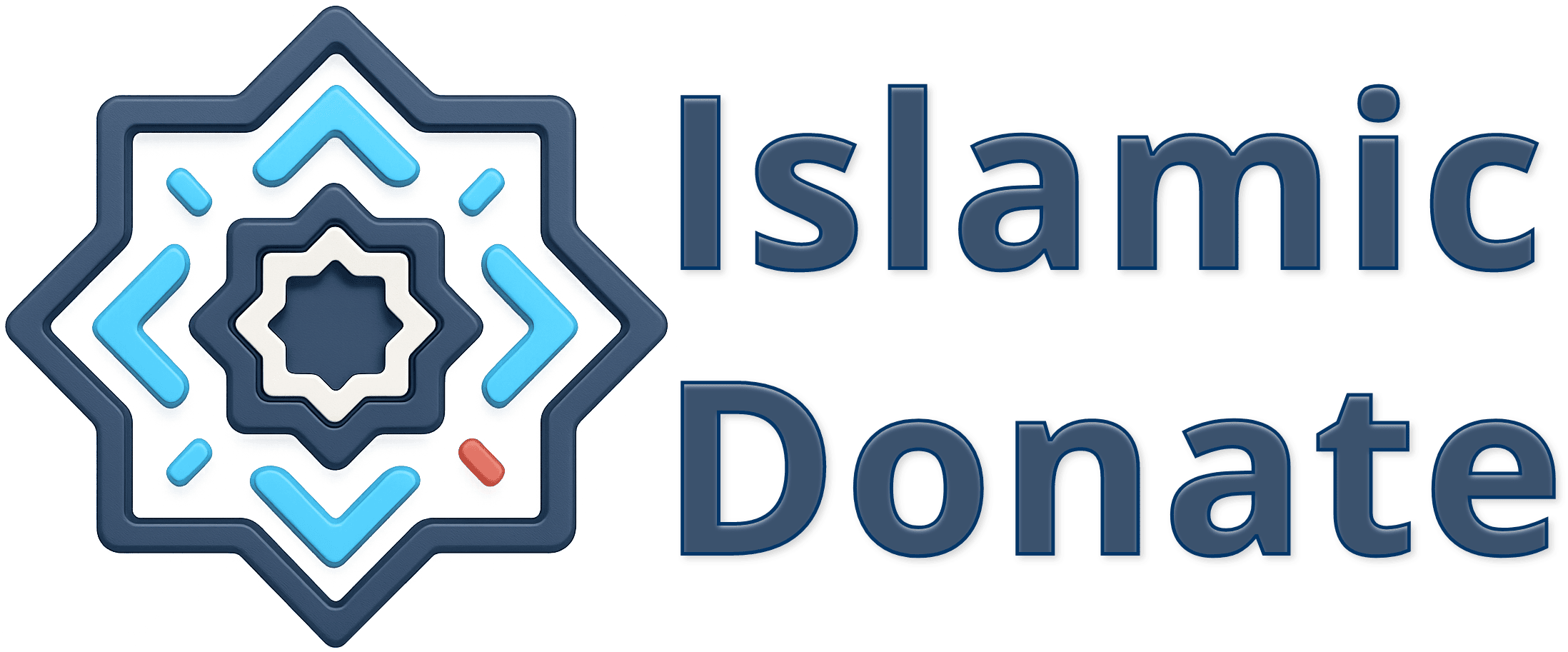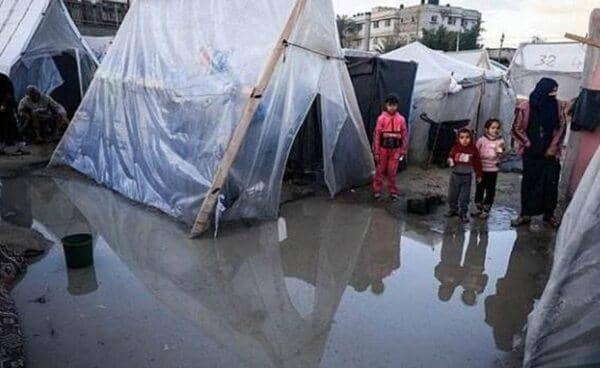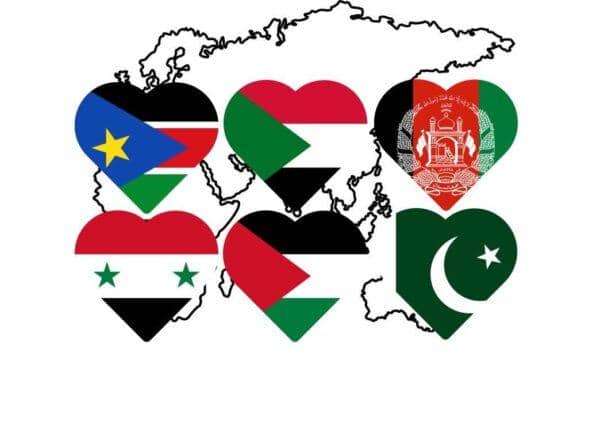يوم عرفة: يوم الصعود من النفس إلى الخالق
يعتبر التاسع من شهر ذي الحجة الإسلامي ، وهو قبل يوم واحد من عيد الأضحى ، يومًا مهمًا ومقدسًا جدًا للمسلمين. وفي مصادر الروايات بعض الأعمال التي يُنصح بأدائها في هذا اليوم ، وأهمها الدعاء والاستغفار. كما نوصي بشدة بزيارة الإمام الحسين وتلاوة دعاء العرفة.
“عرفة” هي كلمة عربية تعني الفهم والفهم جنبًا إلى جنب مع التفكير والتفكير في تأثير الأحداث. اشتق اسم “عرفة” من أرض عرفات (مكان في مكة يقيم فيه الحجاج في هذا اليوم). ويقال أن أرض عرفات سميت بذلك لأنها أرض معرّفة ومعروفة بين الجبال. وسبب آخر هو أن الناس في هذه الأرض يعترفون بخطاياهم ويصبرون على الضيق ، والصبر من معاني “عرفة”.
وقد تعددت الروايات التي تذكر يوم عرفة على أنه يوم خاص يغفر الله فيه ويستجيب لدعواتنا.
كما اعتبر الأئمة الشيعة هذا اليوم مقدسًا ونصحوا الناس بتعظيمه. لم يرسلوا أبدًا أي شخص محتاج خالي الوفاض في هذا اليوم. وفي رواية أن الإمام السجّاد (ع) سمع سنة في يوم عرفة رجلا محتاجا يستغيث الناس ، فقال له: ويل لك ، هل تسأل غير الله في هذا اليوم؟ في هذا اليوم ، هناك أمل في أن يحالف الحظ حتى الأطفال في الرحم برحمة الله “.
ومن أهم الأعمال في هذا اليوم قراءة دعاء عرفة الإمام الحسين. هذه بعض النقاط البارزة في الدعاء:
– التعبير عن الإيمان ، والتأمل في الآيات ، وتذكر نعمة الله التي لا تنتهي على البشر ، وحمده وشكرها عليها.
التعبير عن التواضع لله ، والاعتراف بالذنب ، والاستغفار ، والالتفات إلى الخير.
التعرف على الأنبياء ، وتوثيق علاقتنا بهم ، وزيادة الوعي بالآخرة.
التعرف على الله وصفاته وتجديد يميننا مع الخالق
الدعاء لحاجاتنا ابتداء من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبركاته وخيراته وزيادة الرزق والثواب في الآخرة …
في الواقع ، دعاء العرفة طريق يبدأ بمعرفة أنفسنا وينتهي بمعرفة الله. كما نعلم ، فإن أحد أهم أسس ترسيخ الفضائل في أنفسنا والوصول إلى الكمال الروحي هو معرفة أنفسنا أولاً. حتى لا نضع هذه المرحلة الصعبة وراء أنفسنا ، لا يمكننا الوصول إلى درجات روحية أعلى. لهذا السبب بالذات ، يؤكد معلمو الروحانية العظماء أن من يريد أن يسير في طريق الروحانية ، يجب أن يعرف نفسه أولاً ولا يتجاهل هذا الشرط الأساسي بأي حال من الأحوال.
يشير الحديث الشهير “من يعرف نفسه يعرف ربه” إلى هذا المفهوم بالذات. في كتاب بيهار الأنوار ، كتاب النبي إدريس ، الفصل الرابع ، المتصل بالحكمة ، جاء فيه: “من عرف الخلق عرف الخالق ، ومن يفهم الرزق يعرف الرازق ، ومن يعرف نفسه يعرفه”. ربه.
إذا أدرك الإنسان عظمة هذا اليوم وفهم أعماق دعاء العرفة ، فسوف يمر بيوم مليء بوعي الله إن شاء الله.
المترجم: سافورة ترقي
المترجم: فاطمة الزهراء