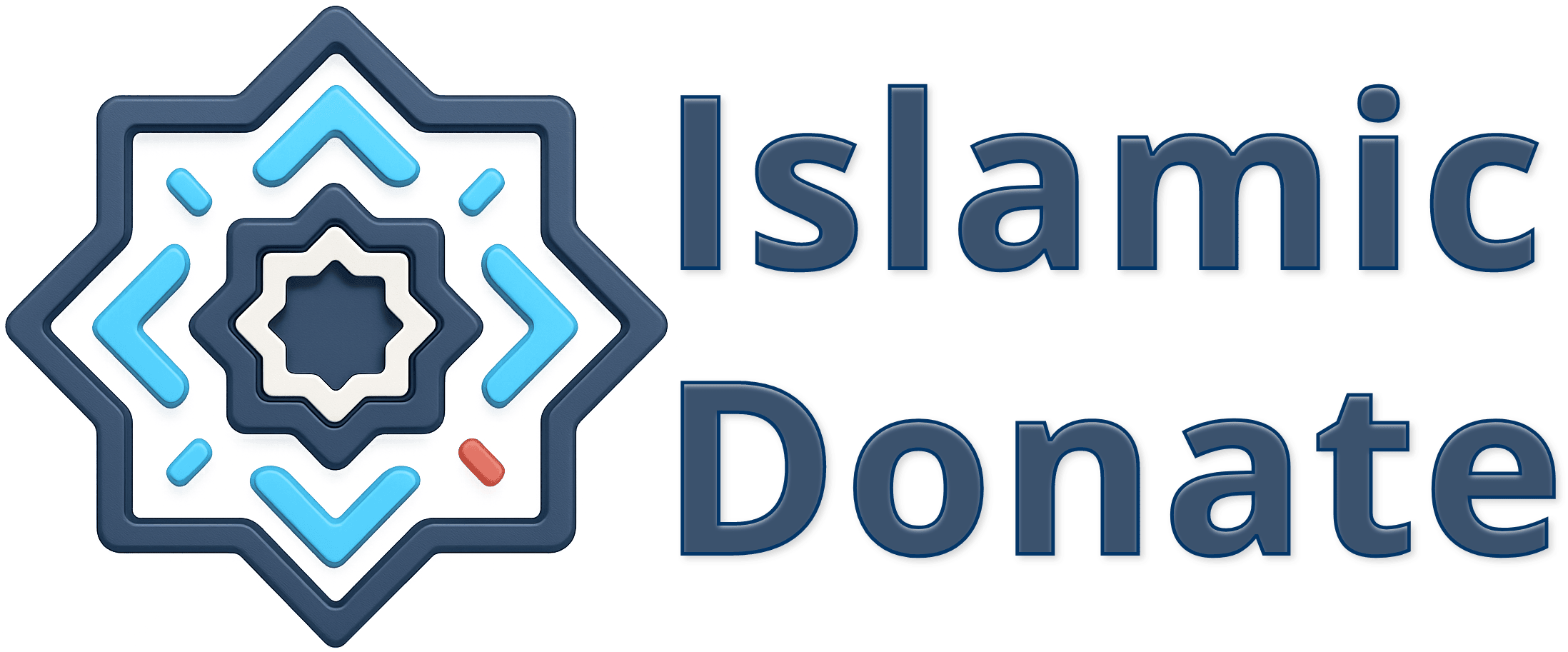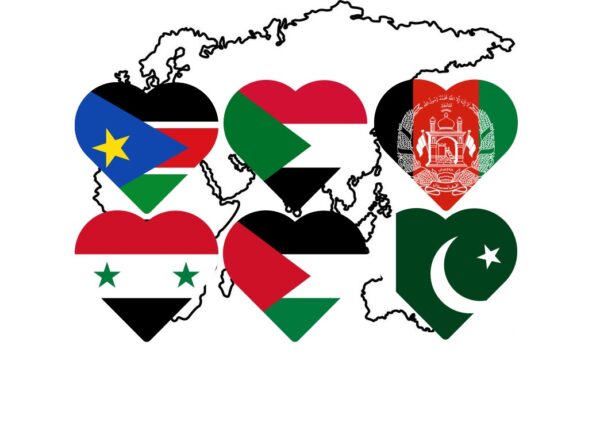زكاة الفطرة أو الفطر، واحدة من الزّكوات الواجبة على المسلمين، يؤدّونها عن الأفراد والأشخاص لا عن الأموال، فزكاة الأموال تطهير للمال، وزكاة الفطرة زكاة للأبدان والنّفوس.
ولزكاة الفطرة أحكام مذكورة في الكتب الفقهية منها أن يدفع المكلف عن نفسه وعمّن يعوله، من ولد ووالد وزوجة ومملوك وضيف مسلماً كان أو ذمياً، صغيراً وكبيراً.
تاريخ تشريعها
الظاهر أنها شُرّعت مع تشريع صوم شهر رمضان، في السنة الثانية من الهجرة؛ وذلك لأنها تضاف إلى الإفطار بعد صوم رمضان، فهي تابعة له، ولم يُذكر أنّ المسلمين صاموا قبل تلك السنة أو بعدها، ولم يخرجوا زكاة الفطرة.
الحكمة من تشريعها
إنَّ الحكمة التي تبنّاها الشارع المقدّس من تشريع زكاة الفطر هى إغناء الفقراء عن ذل السؤال في هذا اليوم، بالإضافة إلى تقاسم الفرح والسرور على الأغنياء والفقراء.
وهي تطهير مما وقع فيه مما يتنافى مع حكمة الصوم وأدبه، فتكون زكاة الفطر بمثابة جبرٍ لهذا النقص، وهي طهارة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين.
وهي أيضاً طُعمة للمساكين والفقراء والمعوزين؛ ليشاركوا بقية الناس فرحتهم بالعيد؛ ولهذا ورد في بعض الأحاديث: «أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم». يعني أطعموهم، وسدُّوا حاجتهم؛ حتى يستغنوا عن الطواف والتكفف في يوم العيد، الذي هو يوم فرح وسرور.
حكمها
زكاة الفطرة واجبة، وتجب فيها النية كغيرها من العبادات.
مَن يجب عليه إخراجها
تجب على كل:
- مكلف بالغ
- حرّ غير مملوك، وفي المكاتب احتياط
- مالك لما يجب فيه زكاة المال
مَن يجب إخراجها عنه
يدفع المكلف عن نفسه وعمّن يعوله، من ولد ووالد وزوجة ومملوك وضيف مسلماً كان أو ذمياً، صغيراً وكبيراً، حرّاً وعبداً، ذكراً وأنثى.
- الشخص الذي يحل ضيفاً على آخر ليلة العيد لا يعتبر داخلاً في العيلولة بمجرد الضيافة ما لم تتحقق العيلولة ولو مؤقتاً كأن ينام عنده ليلة العيد.
من يسقط عنه وجوبها
لا يجب إخراج زكاة الفطرة على:
- الصبي والمملوك والمجنون المطبق والإدواري، والمغمى عليه عند دخول غروب ليلة العيد.
- الفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلاً أو قوة. ولكن يستحب له إخراجها أيضاً.
فطرة السادة
تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره، والعبرة على المعيل دون العيال.
المتولي لإخراجها يجوز أن يتولى الإخراج من وجبت عليه، أو يوكل غيره في التأدية ، فحينئذ لا بد للوكيل من نية التقرب، وإن وكله في الايصال يجب عليه أن ينوي كون ما أوصله الوكيل إلى الفقير زكاة.
محل إخراجها
تًخرج في مكان تواجد المزكي ، ويحتاطون في إخراجها حتى إلى بلده الأصلي في حال وُجد في بلد الإخراج فقير .
المستحق للفطرة
مصرف زكاة الفطرة هم الأصناف الثمانية، وقيل إنها تختص بـ :
- الفقراء
- والمساكين
والأفضل تقديمها للفقير أو المسكين من الأقارب لو كان موجوداً في بلد إخراج الزكاة .
مقدارها
الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوت الغالب في الجملة: صاعاً من التمر، أو الزبيب، أو البرّ (الحنطة) أو الشعير، أو الأرز أو الذرة، أو الأقط، أو اللبن، ونحوها. ولا بأس أن تدفع قيمته المالية.
والصاع يساوي ثلاث كيلوات تقريباً
ويجزي دفع القيمة من النقدين وما بحكمهما من الأثمان .
والمدار على قيمة وقت الأداء لا الوجوب، وبلد الاخراج لا بلد المكلف . اضغط هنا لدفع زكاة الفطر.
وقت وجوبها
المشهور أنه يعتبر اجتماع الشرائط آناً ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب.
ووقت إخراجها طلوع الفجر من يوم العيد، والأحوط إخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد، وإن لم يصلّها امتد الوقت إلى الزوال، وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي. وإذا عزلها تعينت، فلا يجوز تبديلها.