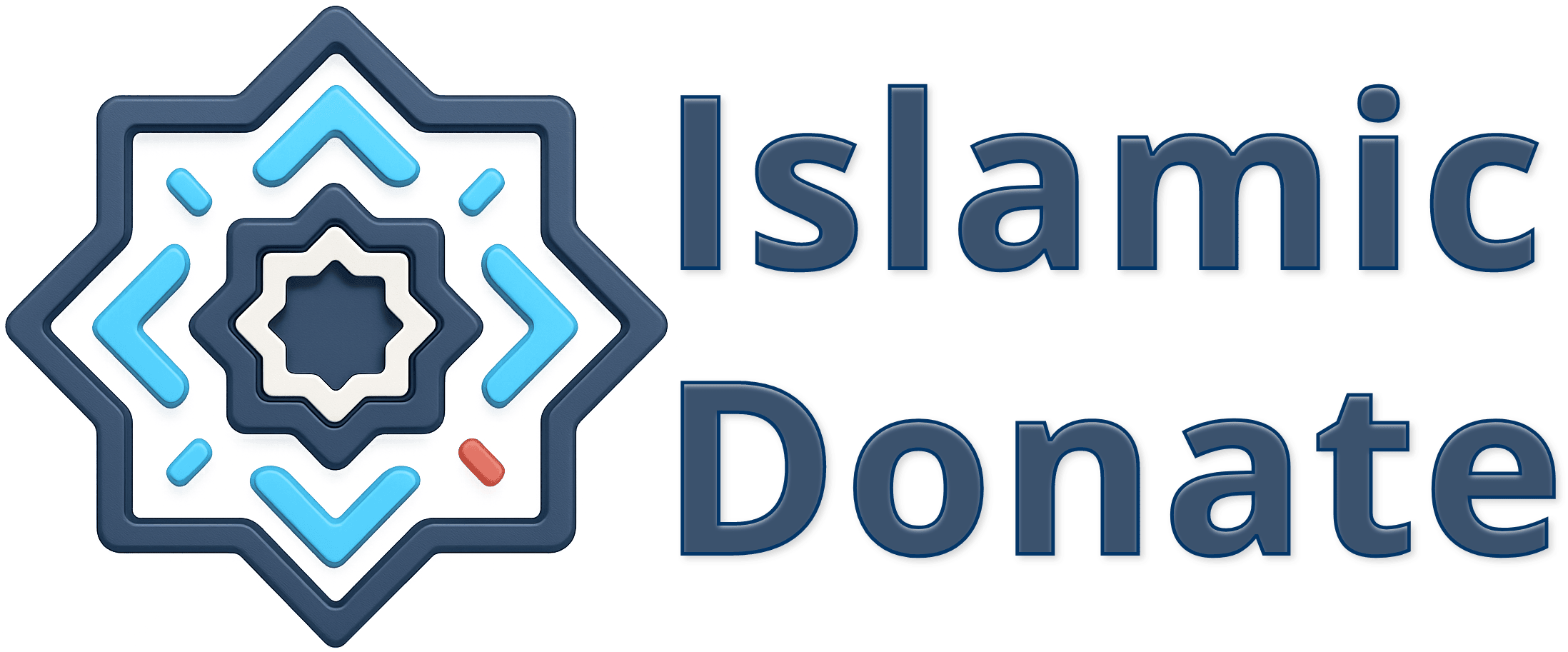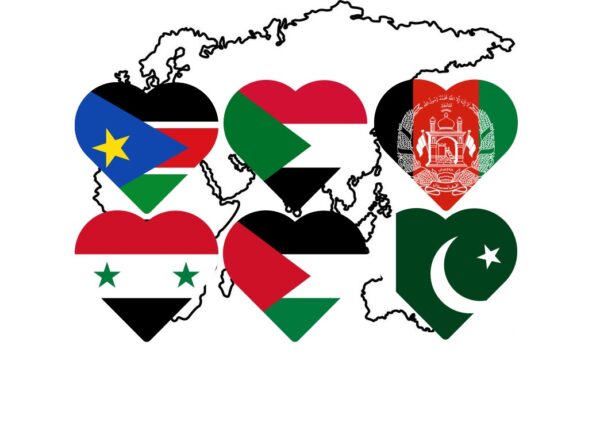محمد باقر اقى نجفي يوفاهاني (بالفارسية: محمدباقر آقانجفی اصفهانی ، مواليد 1234 / 1818-19 ، ت 1301/1883) كان عالمًا إماميًا في الفقه ومبادئ الفقه في القرن الثالث عشر / التاسع عشر. درس في أصفهان والنجف مع حسن كاشف الغيطع والشيخ محمد حسن النجفي صاحب جواهر الكلام والشيخ مرتضى الأنصاري ، ثم عاد إلى أصفهان. وأكد على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وله منصب القضاء والفتوى. أشار إليه الناس لحل مشاكلهم. وهكذا ، فقدت الحكومة المحلية في أصفهان نفوذها وقوتها. كان يحظى بشعبية كبيرة بين الناس. وكان محمد تقي نجفي وآقا نور الله أصفهاني ولديه.
ومن بين طلابه السيد إسماعيل الصدر ، والسيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي ، وشريعة أصفهاني.
النسب والأطفال
والد محمد باقر هو محمد تقي ب. ميرزا عبد الرحيم الإيواناكي الطهراني المسجد شاهي المعروف بمحمد تقي الرازي الذي كتب عرضاً لمعلم الشهيد آل ثاني بعنوان هداية المسترشدين. نشأ محمد تقي في العراق لأن والده ميرزا عبد الرحيم هاجر إليها. ومع ذلك ، بعد الانتهاء من دراسته في العراق ، عاد محمد تقي إلى إيران وأقام في أصفهان. ألقى محاضرات في مسجد شاه (مسجد شاه) في أصفهان. كان الإشراف على هذا المسجد لأبنائه ، وبالتالي أصبحوا يعرفون باسم “مسجد شاهي”. آقا نجفي هو حفيد لأم الشيخ جعفر كاشف الغيطع. كان محمد باقر يبلغ من العمر 13 عامًا عندما توفي والده ، فربته والدته.
آقا نجفي تزوج ثلاث مرات وأنجب 6 أبناء و 3 بنات. كان جميع أبنائه من علماء الدين. أبناؤه هم محمد تقي (الذي كان المرجع بعد والده) ، وآقا نور الله (عالم دعم الحركة الدستورية في إيران) ، ومحمد حسين ، وجمال الدين ، وإسماعيل ، ومحمد علي.
تعليم
بدأ محمد باقر دراسته في أصفهان بحضور محاضرات لعلماء المدينة. بعد زواجه ، انتقل إلى العراق لمواصلة تعليمه. درس الفقه مع خاله الشيخ حسن كاشف الغيطع مؤلف أنور الفقهاء والشيخ محمد حسن النجفي مؤلف جواهر الكلام ودرس أصول الفقه مع الشيخ مرتضى. الأنصاري. حصل على إذن بنقل الأحاديث من هؤلاء العلماء. كان من أوائل طلاب الشيخ الأنصاري. درس في البداية شروح والده على معلم الأصول. أصبح آقا نجفي عالماً رفيع المستوى وعاد إلى أصفهان.
طلاب
بعد عودته إلى أصفهان ، بدأ آقا نجفي التدريس في مسجد شاه ، حيث اعتاد والده التدريس. من بين طلابه علماء مثل ميرزا محمد حسين نعيني ، السيد إسماعيل الصدر ، السيد محمد كاظم طباطبائي يزدي ، شريعة أصفهاني ، وابنه محمد تقي (الذي أصبح معروفًا مؤثرًا). عالم في حياة والده).
يعمل
تشمل أعمال محمد باقر:
لب الفقه. كتب في سن الثانية والثلاثين. فقط مجلد غير مكتمل من كتاب الطهارة لقسم الوضوء متوفر في مكتبة حسن صدر الدين.
رسالة حجية الزن الطريق. تم نشره مع والده هداية المسترشدين.
لُب الأصول
أنشطة اجتماعية
بعد عودته إلى أصفهان ، أصبح محمد باقر أصفهاني قائد صلاة الجماعة وشغل منصبًا تعليميًا في مسجد شاه في المدينة. بعد وفاة علماء أصفهان المشهورين ، مثل السيد أسد الله ، ازداد نفوذه الديني والاجتماعي حتى تمكن من تنفيذ أحكام الشريعة. وبما أنه شدد على “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” وكان له منصب القضاء والفتوى ، فقد انخرط في شؤون الناس وفصل في قضاياهم. أشار إليه الناس لحل مشاكلهم. وهكذا ، فقدت الحكومة المحلية في أصفهان نفوذها وقوتها. وكان حاسما في معاملته للكافرين والمرتدين فقتل بأمر منه بعض البهائيين. علاوة على ذلك ، أمر في يوم واحد بإعدام 27 شخصًا: تم تنفيذ الأمر في حالة 12 شخصًا ، وهرب الباقون. كانت فتاواه مؤثرة فيما يتعلق بالمشاكل القانونية. كانت هناك علاقة جيدة بينه وبين زيل السلطان.
الهجرة الى النجف والموت
كان آقا نجفي يحظى بشعبية كبيرة بين الناس لأنه ساعدهم في حل مشاكلهم. ولما قرر عام 1300 هـ / 1882 م الهجرة إلى النجف من أجل الإقامة في العتبة العليا ، اجتمع أهالي أصفهان حول منزله ولم يسمحوا له بمغادرة المدينة. ومع ذلك ، غادر اصفهان بين عشية وضحاها.
بعد وقت قصير من وصوله النجف ، توفي آقا نجفي في سفر عام 1301 / كانون الأول 1883 ، ودفن في مقبرة جده الشيخ جعفر كاشف الغيطع.